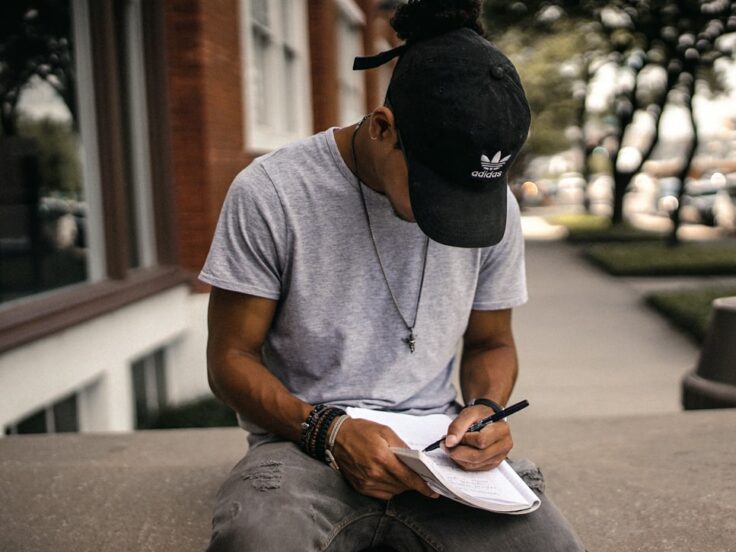غالباً ما تُعتبر فترة الجامعة “أجمل الأوقات في حياتكم”. فهي فصل من المرح والحرية واكتشاف الذات. ولكن بالنسبة للشباب العرب، يمكن لتلك التجربة أن تكون أكثر تعقيداً وصعوبة.
فمع ارتفاع الرسوم الدراسية وازدياد البطالة، يزداد كفاح وقلق العديد من الطلاب. ووفقاً لاستطلاع في عام 2018، أفاد 43% من الطلاب بأنهم لطالما كانوا يشعرون بالقلق.
كما أن الواقع أكثر صعوبة بالنسبة لطلاب المجتمعات المهمشة الذين يتركون منازلهم للدراسة في الخارج لأول مرة. حيثُ كشفت صحيفة الاندبندنت أن الحوادث العنصرية التي تحدث في الحرم الجامعي ازدادت بنسبة 60% بين عامي 2016 و2018 – وعلى الرغم من أن هذه النسبة مثيرة للقلق، إلا أن الجامعات لا تزال عاجزة عن معالجة هذه القضية الملحة.
وفي خضم فصل دراسي جديد، التقينا بخمسة طلاب عرب (وخريجين جدد) لمعرفة كيف صقلت الجامعة هوياتهم وكيف تعاملوا مع العنصرية.
سالم، 30 عاماً، مغربي
“بعد قضاء فترة أكاديمية ناجحة في وطني، قررت الانتقال إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة دراسة أخرى، وحصولي على بطاقة الإقامة الدائمة باليانصيب قبل بضع سنوات سهل علي الوصول إلى هناك. وحقيقة أن مشروع البحث الذي اخترته كان صعباً وأن مستشاري رغم أنه كان لطيفاً جداً ولكنه ليس حاضراً دائماً (للعديد من الأسباب)، تركتني أشعر بالضياع والوحدة مرات عديدة وأعتقد أنها ربما تسببت لي بنوعٍ من متلازمة الدجال أو المحتال (وهي ظاهرة نفسية يشك فيها المرء بإنجازاته ويصبح لديه خوف داخلي دائم من أن يعتبره الآخرون «محتالًا»)، إذ اعتقدت أنني كنت محتالاً ولست ذكياً بما يكفي وأنه ربما علي العودة لبلدي أو أنني لا أستحق المنحة الدراسية التي حصلت عليها. كل ذلك جعلني أشعر بعدم الأمان. وأحاول عموماً ألا أفكر في العنصرية بهذه الحالة لأنها تحبطني حقاً، ولكنني اختبرت ذلك الشعور بالفعل عندما كنت أبحث عن مستشار وتحدث إليّ أحد الأساتذة وكأنني لا أملك أي شهادات حقيقية. وعلمت في وقت لاحق من قِبَل أشخاص آخرين أنه كان يعتقد بأنني التحقت بالمدرسة للحصول على التأشيرة والإقامة في أميركا فقط. ولحسن الحظ، كان لدي أصدقاء يدعمونني، وكانوا معظمهم من الطلاب الدوليين الذين يعانون من صراعات مماثلة لصراعاتي، مما ساعدني على الاستمرار. كما كان في الجامعة أيضاً برنامجاً لمساعدة الطلاب على التغلب على القلق والتوتر في المدرسة، ولكنني لم أستعن به مطلقاً، وربما كان ينبغي علي ذلك”.
ياسمين، 23 عاماً، كويتية
“لطالما اعتقدت أن الدراسة في لوس أنجلوس ستكون فكرة رائعة باعتبار أنني نشأت وأنا أقضي فصل الصيف بكامله في لوس أنجلوس. ولكن الامر لم يكن كما توقعته على الإطلاق. لم تكن العنصرية هي السبب، بل مجرد الجهل والنقص في المعرفة. لقد شعرت بوحدةٍ شديدة، ولكنها أثرت علي بطريقة جيدة وليست سيئة. فرغم صعوبة أنني وحدي، علمني ذلك كيف أطور نفسي وأتعرف عليها أكثر، وما الذي أريده وأحبه في الحياة. فأنا نشأت بوجود الكثير من الأصدقاء حولي وانتقالي إلى لوس أنجلوس كان عكس ذلك تماماً. ثم انتقلت مؤخراً إلى نيويورك، التي وجدتها كما توقعتها تماماً إن لم يكن أفضل. فقد ساعدتني هذه المدينة على إبراز شخصيتي الحقيقية وسمحت لي بالتعبير عن نفسي بطرق لم أستطعها عندما كنت في لوس أنجلوس. فعندما أكون في مدينة تعمل على إخراج الطفلة الموجودة بداخلي، أعلم حينها بأنني في المكان والبيئة الصحيحتين. كما أن الأماكن التي أزورها هنا لا تسمح لي باختبار شعور العنصرية. حيثُ أحضر الفعاليات التي عادة ما تكون فيها حشود مختلطة. فهنا لا أشعر بالوحدة على الإطلاق وأصبحت بالتأكيد أكثر جرأةً وصراحةً في طلب المساعدة إذا ما احتجتها. ولكن بالمجمل أنا أستمتع بالعيشة في الخارج أكثر بسبب نمط الحياة، حتى أنني أفضلها عن العيشة في بلدي. إذ يعجبني كثيراً اهتمام الناس بشؤونهم هنا، الأمر الذي غالباً ما يصعب على الناس في الشرق الأوسط القيام به”
بلقيس، 20 عاماً، تونسية
“انتقلت إلى باريس للدراسة. ولكنني أمضيت الفصل الدراسي الأول بالخروج باستمرار وبالتالي رسبت في ذلك الفصل، ولكنني نجحت في الفصل الثاني. إلا أن هناك شيء واحد لا أزال أذكره وهو أنني عندما أخبرت أحد الأصدقاء بأنني أتيت من تونس أجاب “هل جئتِ إلى هنا لتفجير قنبلة أو لتنفيذ هجوم إرهابي؟”، فأجبته بأن “القنبلة الوحيدة هنا هي أنا”، فكلمة قنبلة باللغة الفرنسية تعني أنني مثيرة. كما كان لدي أيضاً مجموعة من الأصدقاء الذين كنت مضطرة دائماً لإثبات نفسي أمامهم وإثبات أنني أستحق العيش هنا (لقد عاش والدي في فرنسا لمدة 30 عاماً، وهذا سبب حصولي على الجنسية الفرنسية). واجهت بالتأكيد بعض الصعوبات هنا مثل التعامل مع من أكون، وهل أنا تونسية حقاً أم أنني فرنسية؟ وإلى أين أنتمي؟ لكنني فهمت الآن بأنني أكثر من مجرد بلدٍ أو جنسية. لقد ساعدني التواجد في فرنسا على تحقيق حلمي بأن أصبح صحافيةً ومتدربةً في المجلات الكبرى وبأن أسافر في رحلات عمل. لقد ازداد طموحي أكثر في باريس بينما كنت خائفةً جداً في تونس، حيث لا توجد فيها الكثير من الفرص”.
لانا، 22 عاماً، لبنانية
“أعتقد أنكم لن تدركوا ما الذي يعنيه الشعور بالإختلاف إلا في اللحظة التي تسافرون فيها وحدكم من الشرق الأوسط للدراسة في الخارج. لقد عشت طوال حياتي في فقاعة كانت تجعلني أشعر بالأمان. وعلى الرغم من دعم والداي المالي لي ومن أنني لم أكن “معزولة” حقاً، لكنني كنت أشعر بالاستغراب عندما أسمع الناس يسألونني باستمرار عن هويتي وبأنني مختلفة، حتى أنهم كانوا بتجاهلونني في بعض الأحيان. ولكن هذا ساعدني على معرفة المزيد عن المكان الذي أتيت منه واحتضان ثقافتي وروايتي، كما أنني سعيدة للغاية للمشاركة في هذه المحادثة. فأن تكونوا من الشباب العرب أمراً لا يزال مستهجناً إلى حد ما بالنسبة للكثيرين وهذا أريد تغييره”.
سامي، 24 عاماً، تونسي
“الانتقال إلى مدينة أوروبية للدراسة أمر شائع للغاية بين الشباب العربي، فما يبيعونه لنا هو التجربة وحرية وجودة التعليم، لكن ما لا يخبروننا به بالتأكيد هو الجانب المظلم من هذه التجربة وهي التمييز والعزلة والنضال لبناء حياة جديدة. عندما وصلت إلى باريس، اضطررت إلى التخلي عن كل ما قمت ببنائه بالفعل وبدء كل شيء من جديد (معالم جديدة وأصدقاء جدد ورؤية جديدة للأشياء، الأمر الذي كان محبطاً بالفعل). أذكر مرةً أنني كنت عائدأ إلى شقتي بالمترو في يومٍ بارد وذرفت الدموع لأنني أردت العودة إلى المنزل لأجد شخصاً يفتح لي الباب ويعانقني ويعطيني صحن من الحساء الساخن ويخبرني أن كل شيء يسير على ما يرام. لم أتمكن من التخلص من شعور الحنين إلى الوطن. فروحي تنتمي إلى وطني ولكن جسدي عالق هنا مؤقتاً. كما أن فرنسا ليست المكان الأكثر أماناً للمهاجرين والمغتربين (العرب المسلمين)، فالأمور هنا أكثر صعوبة بالفعل. فعندما يكون لديكم أصدقاء فرنسيين من ذوي البشرة البيضاء تمضون وقتاً معهم، فسيعاملونكم أبناء مجتمعكم على أنكم بيض مثلهم، وعندما تقومون ببناء علاقاتٍ قوية مع أشخاص من مجتمعكم، فسيُطلق عليكم مباشرةً لقب الطائفيين. وفوق كل ذلك – غالباً ما يُطلق علي اسم blédard (وهو مصطلح دوني يعني العرب المنبوذين أو غير المندمجين في محيطهم). وهو اسم أُطلق عليي من قبل أشخاص من مجتمعي”.